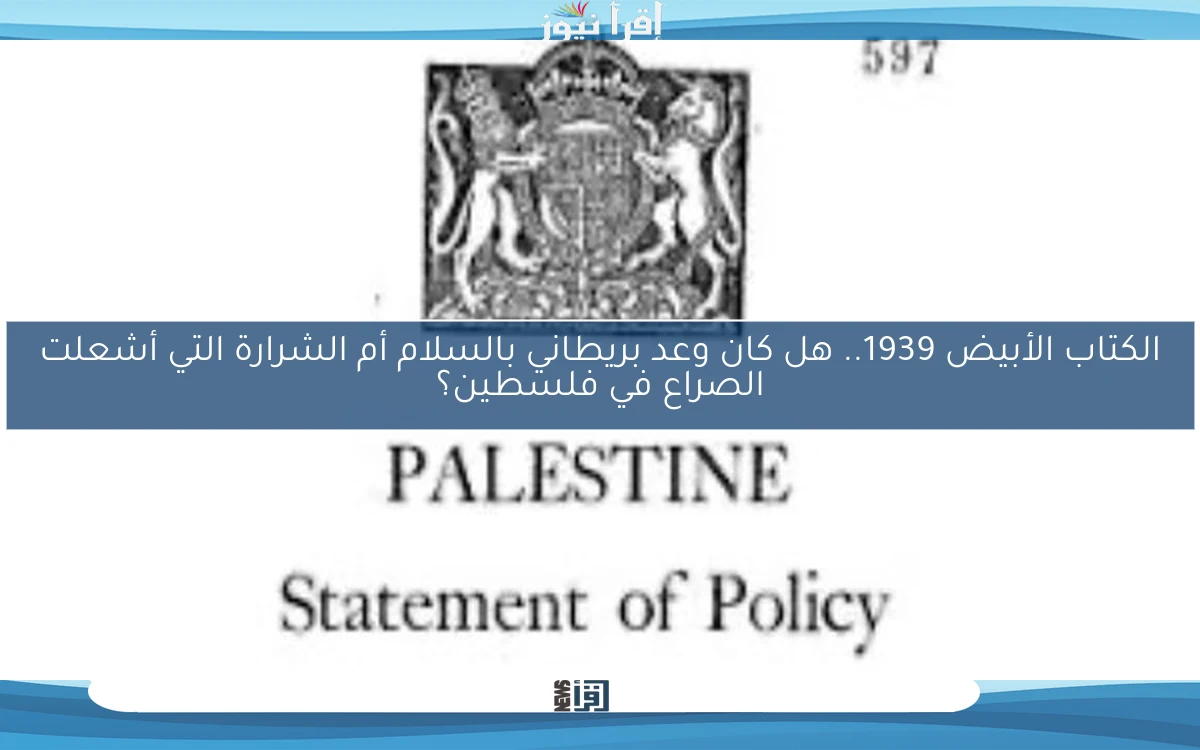
في مايو من عام 1939، أصدرت الحكومة البريطانية وثيقة تاريخية تُعرف باسم “الكتاب الأبيض”، حيث سعت لندن من خلالها إلى إعادة ضبط سياساتها في فلسطين، التي كانت تحت الانتداب البريطاني منذ عام 1920، وجاء هذا الكتاب في ظل ظروف مشحونة بالتوتر، بعد اندلاع الثورة الفلسطينية الكبرى (1936–1939) التي كانت رد فعل على زيادة الهجرة اليهودية بدعم بريطاني، بالإضافة إلى السياسات المتعلقة بالتهجير والاستيلاء على الأراضي التي بدأت تؤثر بشكل كبير على الهوية والمجتمع الفلسطيني.
مثل الكتاب الأبيض تحولًا ملحوظًا في الموقف البريطاني، إذ نصت الوثيقة بوضوح على نية بريطانيا إقامة دولة فلسطينية مستقلة خلال عشر سنوات، تكون مشتركة بين العرب واليهود، كما تضمن النص تقييد الهجرة اليهودية إلى فلسطين بحيث لا تتجاوز 75 ألف مهاجر خلال خمس سنوات، مع ضرورة الحصول على موافقة العرب لأي هجرة لاحقة. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل فرض الكتاب قيودًا صارمة على بيع الأراضي لليهود بهدف تهدئة الغضب المتزايد للعرب الذين كانوا يشعرون بأن وطنهم يُسلم تدريجيًا لحركة استعمارية منظمة.
وعلى الرغم من أن الوثيقة حملت في طياتها اعترافًا بالحقوق العربية، إلا أنها قوبلت بردود فعل متباينة من مختلف الأطراف المعنية.
فقد رأت القيادة العربية في تلك الخطوة تأخرًا واضحًا بعد سنوات طويلة من المقاومة والثورات الشعبية، واستقبلتها بحذر شديد نظرًا لعدم الثقة بالوعود البريطانية المتكررة والتي لم تكن دائمًا موثوقة. أما بالنسبة للحركة الصهيونية، فقد اعتبرت الكتاب بمثابة خيانة صريحة لوعد بلفور الذي صدر عام 1917 والذي أكد على إنشاء “وطن قومي لليهود” في فلسطين. ونتيجة لذلك اندلعت احتجاجات واسعة النطاق بين صفوف اليهود وصلت إلى حد تشكيل منظمات عسكرية لمواجهة الانتداب البريطاني.
وفي السياق الدولي، أثار الكتاب الأبيض جدلًا كبيرًا خاصة وأنه صدر قبل فترة قصيرة من بداية الحرب العالمية الثانية. وقد اعتبره البعض محاولة من بريطانيا لكسب ود العالم العربي لمواجهة التهديد المتصاعد من ألمانيا النازية بينما رأى آخرون أنه يعكس أزمة استعمارية عجزت فيها بريطانيا عن التوفيق بين التزاماتها المتناقضة تجاه العرب واليهود.

تعليقات